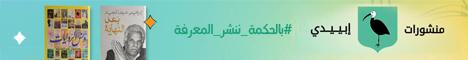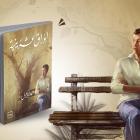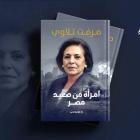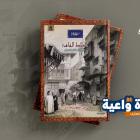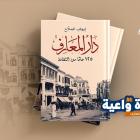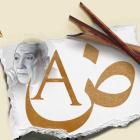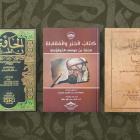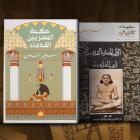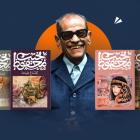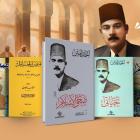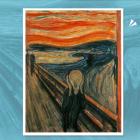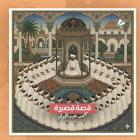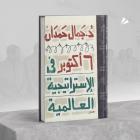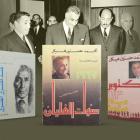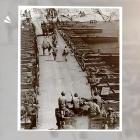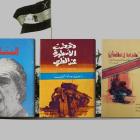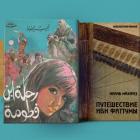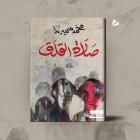سعادتي لا توصف بإتمام الاتفاق أخيرًا مع أسرة المرحوم الدكتور محمود علي مكي (الذي أخصص له هذا المقال والمقالات التالية) لنشر كامل أعماله المطبوعة التي سبق نشرها، أو تلك التي لم تُنشر من قبل ولم تُجمع بين دفتي كتاب. وتشمل أعماله تلك مؤلفاته، وترجماته، وتحقيقاته، ومقالاته، وبحوثه، ومقدماته التي كتبها لأعمال أدبية أو ترجمات أو تحقيقات تراثية... إلخ.
ذكرى الرحيل
اعذرني ـ قارئي العزيز ـ فقد هجمتُ عليك هكذا فجأة، ودون سابق إنذار بإعلان هذا الاتفاق، وبإعلان سعادتي الغامرة به، ودون أن أُمهّد لك الحديث عن هذا العالِم الجليل والأستاذ المكين الدكتور محمود علي مكي (1929 - 2013)، عميد الدراسات الأندلسية والتراث الأندلسي في الجامعات العربية والإسبانية، وصاحب التاريخ المُشرّف والأعمال العظيمة التي سنحاول في هذا المقال والمقالات التالية أن نكشف عنها، وعن سر نعتي لها بالعظمة، وقيمتها، وضرورة نشرها وفق مشروع محدد المعالم، واضح القسمات، نبدأ في تنفيذه قريبًا بإذن الله في مؤسسة دار المعارف...
لكني أولًا، وقبل التعريف بالأستاذ الجليل، الذي تحل ذكرى رحيله الثالثة عشرة في السابع من أغسطس (إذ توفي الدكتور مكي في السابع من أغسطس عام 2013، وهذا هو تاريخ الوفاة الدقيق بحسب ما أكدته لي ابنته العزيزة الدكتورة ماجدة مكي، وعلى خلاف الشائع بأنه توفي يوم 8، وهذا غير دقيق)، أقول: إنني أعود بذاكرتي قرابة ثلاثين عامًا مضت، حيث تلقيتُ أول دروسي في مادة «الأدب الأندلسي» وتاريخه على يدي العلّامة الجليل د. محمود علي مكي، وهو العَلم البارز، أستاذ الدراسات الأندلسية والأدب المقارن في جامعة القاهرة والجامعات العربية والإسبانية.
كنتُ طالبًا في الفرقة الثانية، عندما كان الدكتور مكي أستاذًا متفرغًا، وقد أنجز دراساته ومؤلفاته الفخمة الشاهقة التي مثّلت مكتبة عامرة بكل ما تعنيه كلمة «مكتبة»؛ متنًا ضخمًا يوازي جهد مؤسسات علمية ومراكز بحثية بأكملها.